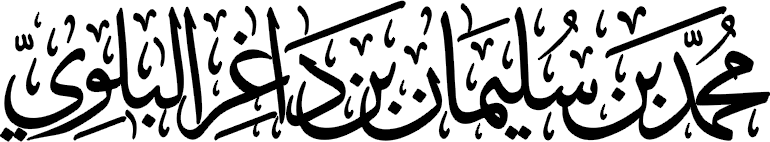لا يوجد في هذه الدنيا مخلوق إلا وقد جُبل على النقص، مهما بلغ من قوة أو علم أو حكمة. فكل مخلوق -مهما علا- يبقى محدودًا بطبيعته، وواقعًا تحت سنن الله في الكون التي لا يحيد عنها أحد.
خذ على سبيل المثال تطوّر الإنسان في علوم الذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ لقد وصل إلى مرحلة أصبح فيها من الممكن أن تدير الروبوتات نفسها، بل وتُنتج غيرها، وتتحكم بأنظمة مدن كاملة، وربما مجتمعات. لكن، رغم هذا الإنجاز المذهل، فإن هذه الروبوتات ليست سوى نتاج لعقل الإنسان المحدود، الذي لا يستطيع تجاوز حدوده إلا بقدر ما أقدره الله عليه ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85].
وإن افترضنا جدلاً أن الإنسان قادر على بلوغ مراتب عظيمة من العلم والمعرفة، يبرز حينها سؤال فلسفي عميق: من الذي يمثل “الإنسان” في هذه العظمة؟ هل هو فلان؟ أو أنت؟ أم تلك النخبة من العلماء؟ الواقع أن الإنسان لا يمثل بمفرده هذه المعرفة، بل هي مجموعات من العقول المتخصصة، كلٌ في مجاله، ولا يُمكن لعقل واحد أن يُحيط بكل ذلك. فالمهندس البارع في تصميم الروبوتات، قد لا يُحسن الطب، والطبيب الماهر في جراحة القلب، قد لا يفقه شيئًا في هندسة البرمجيات!
وهكذا تتجلى محدودية الإنسان في أوضح صورها، فكلما تخصص في مجال، زاد بعده عن غيره من الفنون.
أمثلة على ذلك:
العالِم في الفلك قد لا يُجيد أبسط قواعد الطب.
الاقتصادي المحنّك ربما لا يستطيع إصلاح عطل بسيط في هاتفه المحمول.
المفكر الفيلسوف قد يجهل كيف تُدار الأعمال التجارية.
وهذا التخصص ضرورة، لكنه دليل أيضًا على أن الإنسان لا يستطيع -ولا يمكنه- أن يُحيط بكل شيء، ومن هنا تظهر عظمة قول الله تعالى:
﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 76]